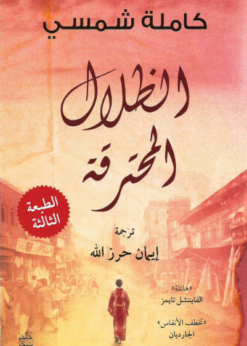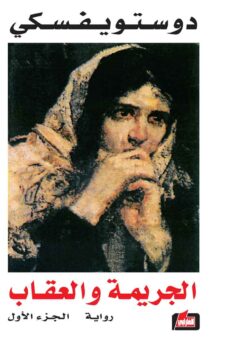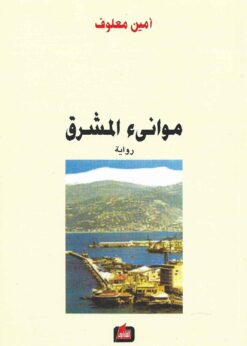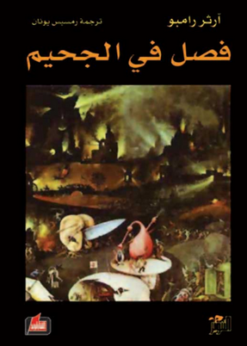اثنتا عشرة قصة قصيرة مهاجرة
0.00$
نفذت الكمية
كان جالساً على مقعد خشبي، تحت الأوراق الصفراء في الحديقة المقفرة، يتأمل البجعات المعفّرة، ويداه تستندان إلى الكرة الفضية في مقبض عكازه، وهو يفكر في الموت.
عندما جاء إلى جنيف أول مرة، كانت الهجرة هادئة وصافية، وكانت هناك نوارس أليفة تدنو لتأكل من الأيدي، ونساء أجرة يشبهن أشباح السادسة مساء بتنانيرهن المصنوعة من الأورغنزة ومطلاتهن الحريرية.
أما المرأة الوحيدة الممكنة الآن، على مدى الرؤية، فهي بائعة أزهار تقف على الرصيف المقفر، ولم يكن بإمكانه أن يصدق أن الزمن إستطاع أن يُحدث مثل هذا الخراب، ليس في حياته وحسب، وإنما في العالم أيضاً.
لقد كان شخصاً آخر مجهولاً في مدينة المجهولين الشهيرين، يرتدي بدلة زرقاء داكنة تتخلها خطوط بيضاء، وصدرية من الحرير، وقبعة قاسية كقبعات القضاة المتقاعدين، وله شارب متشامخ كفرسان العصور القديمة، وشعر كثيف لونه مائل إلى الزرقة، فيه تجعيدات رومنسية، ويدا عازف قيتارة، في بنصر لليسرى فهما خاتم أرمل، وعينان سعيدتان؛ الشي الوحيد الذي كان يشي بحالته الصحية هو إرهاق بشرته.
وبالرغم من ذلك، لا يزال يبدو متأنقاً كأمير وهو في الثالثة والسبعين من العمر، ولكنه كان يشعر في ذلك الصباح بأنه بمنجى عن أي نوع من أنواع الزهو؛ فقد خلّف وراءه، دون رجعة، سنوات المجد والسلطة، ولم يبق أمامه الآن إلا سنوات الموت؛ لقد رجع إلى جنيف بعد حربين عالميتين، باحثاً عن إجابة حاسمة لأنه لم يستطع أطباء المارتبنيك أن يجدوا كهنه.
وكان يتصور أن الامر لن يتطلب اكثر من خمسة عشر يوماً، ولكن ها هي ذي ستة أسابيع قد مضت في فحوصات مرهقة ونتائج مبهمة، وما زالت النهاية غير واضحة المعالم، كانوا يبحثون عن الداء في الكبد، في الكلية، في البنكرياس، في البروستات، حيث لم يكن.
وبقي على تلك الحال حتى يوم الخميس الكريه ذاك، حيث حدد له أقل الأطباء الكثيرين الذين فحصوه شهرة، موعداً في الساعة التاسعة صباحاً، في قسم الأمراض العصبية، كانت غرفة المكتب تبدو وكأنها زنزانة رهبات، وكان الطبيب ضئيلاً وكئيباً، يده اليسرى ملفوفة بالجص بسبب كسر في الإبهام، وعندما أطفأ النور، ظهرت على اللوحة المضاءة صورة شعاعية لعمود فقري لم يعرف أنه عموده الفقري إلى أن أشار الطبيب بمؤشر إلى فقرتين ملتحمتين، تحت الخصر، وقال له: ألمك هنا…
لم يكن الأمر، في نظره بهذه البساطة، فقد كان ألمه محيراً ومتنقلاً، يبدو أحياناً أنه في الخاصرة اليسرى، وأحياناً في أسفل البطن، ويفاجأه في معظم الأحيان بوخز مباعث في أعلى الفخذ، أصغى الطبيب إليه بحيرة والمؤشر ثبت على اللوحة المضيئة، ثم قال له: "لهذا السبب ضلّلنا الداء طويلاً، ولكنا نعرف الآن أنه هنا"، ثم وضع أصبعه على صدغه وقال محدداً: وإن كانت الدقة العلمية تقول، يا سيدي الرئيس، إن أصل الآلام جميعها هنا.
كان أسلوبه في الفحص السريري دراماتيكياً إلى الحد الذي جعل حكمه الأخير يبدو حليماً: على الرئيس أن يخضع لعملية جراحية لا تخلو من مخاطرة، ولكن لا مفر منها، فسأله هذا الأخير عن نسبة المخاطرة، فلفه الطبيب العجوز بضوء من عدم اليقين حين قاله له: لا يمكننا تحديد ذلك بدقة.
"اثنتا عشرة قصة"… هي حكايات في جزء منها نسج الخيال، وفي الجزء الآخر نسجتها واقعية الحياة، هي حكايا استملتها عليه مشاهد حياتية ووقائع أثرت به، وواحدة ظن هذه الحكايا جاءت فكرتها إثر حلم حلم به… "حلم مضى وحلمت به بعد خمس سنوات من العيش في برشلونة، حلمت أنني أحضر مأتمي بالذات، وأنني أقف على قدمي، وأمشي بين جماعة من الأصدقاء يرتدون ملابس الحداد الوقورة، وجميعنا كنا سعداء بإجتماعنا معاً، وكنت سعيداً أكثر من الجميع بتلك الفرصة السارة التي منحني إياها الموت للقاء أصدقاء من أميركا اللاتينية".
فسّر غارسيا ماركيز على أنه وعي لهويته، وفكر في أنه نقطة بداية طيبة لكتابة عن أشياء غريبة تحدث للأمريكيين اللاتنيين في أوروبا، وهكذا رحل خياله وراء هذه الفكرة لينسج هذه الأثنتى عشرة قصة.
منتجات ذات صلة
الكتب العربية
قصص و روايات مترجمة